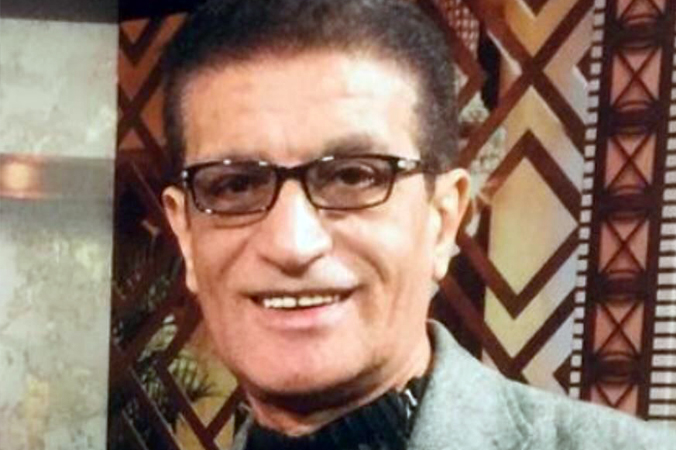من صفحات التاريخ
«أسوار القاهرة» بوابات الثقافة المصرية

مروة مظلوم
ترك الفاطميون بصمتهم فى التاريخ الإسلامى بوجه عام والمصرى بوجه خاص فلم يقتصر على الثقافة المصرية من علوم وفنون وإنما امتد لعاداتهم وتقاليدهم، لا ينكر أحد أن القاهرة كانت درة زمانها يفدها الطلاب من أنحاء العالم للتزود بالعلم والمعرفة وبنيت بها دار الحكمة والأزهر وانتشرت الكتب وجعل المال من أجل الشعراء والأدباء، وارتبطت الكثير من العادات والتقاليد والطقوس بالدولة الفاطمية فى مصر حيث ما زال التأثير الفاطمى يظهر فى مصر أثناء شهر رمضان والأعياد.
ويقول ول ديورانت فى كتابه «قصة الحضارة» أن مصر بدأت نهضتها الحقيقة منذ العهد الفاطمى, حيث بدأت الشخصية المصرية تستقل وتبدأ بالظهور من جديد بروح جديدة إسلامية.
بل إن بعض مؤرخى تاريخ المسرح العربى يرون أن بذور المسرح كانت بدأت فى الظهور فى العصر الفاطمى من خلال ما يسمى بالمهرج والحاوى أثناء الاحتفالات فى العصر الفاطمى.
الأدب والفنون
اهتم الفاطميون منذ أن استقر سلطانهم فى مصر بالعمل على نشر الثقافة العلمية والأدبية، فضلًا عن الثقافة المذهبية التى تتصل بالدعوة الإسماعيلية، كالفقه والتفسير، وكان للجامع الأزهر أثر كبير فى النهوض بالحياة الثقافية فى مصر، وفاقت شهرته جميع المساجد الجامعة فى مصر منذ أن أشار الوزير يعقوب بن كلس سنة 378هـ على الخليفة العزيز بتحويله إلى معهد للدراسة بعد أن كان مقصورًا على إقامة الدعوة الفاطمية، فاستأذنه فى أن يُعيّن بالأزهر بعض الفقهاء للقراءة والدرس على أن يعقدوا مجالسهم بهذا الجامع فى كل جمعة من بعد الصلاة حتى العصر، فرحب العزيز بذلك ورتب لهؤلاء الفقهاء أرزاقًا شهرية ثابتة وأنشأ لهم دارًا للسكنى بجوار الأزهر، وظل الأزهر مركز الفقه الفاطمى إلى أن بنى الحاكم بأمر الله جامعه، فانتقل إليه الفقهاء لإلقاء دروسهم.
العلماء والأدباء
وكان لتشجيع الفاطميين للعلماء والكتّاب أثره فى ظهور طائفة كبيرة منهم فى مصر، فاشتهر من المؤرخين فى العصر الفاطمي، أبوالحسن على بن محمد الشابشتى (388هـ) صاحب كتاب الديارات الذى اتصل بخدمة الخليفة العزيز فولاه خزانة كتبه واتخذه من جلسائه، كما نبغ من المؤرخين الأمير المختار عز الملك المعروف بالمسبحى (420هـ) وكان من جلساء الحاكم بأمر الله وخاصته وشغف بكتابة التاريخ، وألَّف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبير «تاريخ مصر» ومن أعلام المؤرخين أبو عبد الله القضاعى (454هـ) وكان من أقطاب الحديث والفقه الشافعي، له كتاب «مناقب الإمام الشافعى وأخباره» أوفده الخليفة المستنصر بالله سفيرًا إلى تيودورا إمبراطورة الدولة البيزنطية سنة 447هـ ليحاول عقد الصلح بينها وبين مصر. ومن الكتاب المؤرخين الذين ظهروا فى أواخر العصر الفاطمي، أبو القاسم على بن منجب الصيرفى ( 542هـ) الذى اشتهر ذكره وعلا شأنه فى البلاغة والشعر كما برع فى الخط، كذلك نبغ فى العصر الفاطمى بعض العلماء من أمثال محمد بن الحسن بن الهيثم الذى أتى مصر من العراق بدعوة من الحاكم بأمر الله لما بلغه أن له نظرية مهمة فى توزيع مياه النيل، واشتهر من الأطباء والفلاسفة على بن رضوان (460هـ) الذى أصبح بفضل جده واجتهاده رئيس الأطباء فى البلاط الفاطمى.
القراءة للجميع فى القاهرة
كانت المساجد مراكز ثقافية وعمل العزيز بالله على تحويل الجامع الأزهر إلى جامعة يدرس فيها الفقه الشيعى إلى جانب فقه المذاهب الأخرى والعلوم من لغة وطب ورياضة ووفر الفاطميون للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم الإسلامى المسكن والملبس وأنشأوا بالأزهر مكتبة ضخمة بها مخطوطات فى جميع العلوم. اتخذ الفاطميون من قصورهم مراكز لنشر الثقافة الشيعية بصفه خاصة وألحقوا بها مكتبات تحتوى الألوف من الكتب مثل مكتبة القصر الشرقى التى أنشأها الخليفة المعز لدين الله. ويذكر المؤرخون أن الآلاف من الكتب تعرضت للحرق والنهب إبان انقضاء حكم الفاطميين على يد الأيوبيين، ومن الشواهد المتصلة أن ما يعرف فى مصر الآن بتلال الكتب إنما هو فى الأصل المكان الذى جمعت فيه كتب ومخطوطات الفاطميين فأُحرق معظمها وتُرك الباقى لتغطيه الرمال وتدفنه. يذكر المقريزى أن عبيد الأيوبيين عندما سطوا على القصور الفاطمية ونهبوها كانوا ينزعون الجلود التى تغلّف المخطوطات ويتخذون منها نعالًا.
العمارة
جاء فى خطط المقريزى ما يعكس ترف الحياة فى مصر وقت الحكم الفاطمى على مدى مائتى عام على الرغم من أن مذهب الحكام الشيعى يخالف مذهب الشعب الذى يتبع أهل السنة، فكان للفاطميين فى القاهرة قصران متقابلان أحدهما الشرقى وله تسعة أبواب ويبلغ طول واجهته 345 مترًا.
أبواب القاهرة الثمانية
للقاهرة الفاطمية ثمانية أبواب هم صمام أمانها، ولكل باب اسم أطلقه عليه أهلها، عندما بنيت القاهرة عام 969م على يد جوهر الصقلي، أمر بإنشاء سور كبير مبنى من الطوب اللبن على شكل مربع، طول كل ضِلع مِن أضلاعه 1200 ياردة «1080 مترًا»، وقد شيد السور على مساحة 340 فدانًا، وكان الهدف منه هو توفير الحماية والأمن لمدينة القاهرة. ضم السور الكبير ثمانية أبواب فى اتجاهاته الأربعة، حيث بُنى بابان فى كل اتجاه، ففى الشمال «باب الفتوح» و«باب النصر»، وفى الجنوب» باب زويلة» و«باب الفرج»، وفى الشرق» باب المحروق» و«باب البرقية»، وأخيرًا الغرب «باب سعادة» و«باب القنطرة»، ولم يتبقَ من تلك الأبواب الثمانية إلا ثلاثة أبواب فقط هى: باب الفتوح، وباب زويلة، وباب النصر.
باب النصر
يعتبر بوابة القاهرة الشمالية، وهو أول الأبواب التاريخية التى بنيت فى العصر الفاطمى، حيث أمر جوهر الصقلى حاكم مصر ببنائه عام1087 هـ/480م، ويقع فى الضلع الشمالى لسور القاهرة، ووفقًا لنصه التأسيسى المكتوب، فقد كان الهدف من إنشائه هو حماية القاهرة، وقد تم استخدمت فى بنائه أحجار تم تفكيكها من المعابد المصرية القديمة، لذا يحتوى على نقوش هيروغليفية، وقد شهد باب النصر العديد من الأحداث التاريخية، فقد كانت الجيوش المنتصرة تمر من خلاله، أثناء عودتها من المعارك والغزوات، ولذا سمى بباب النصر.
يتكون الباب من برجين كبيرين يحتويان على نقوش حربية، وهما يتكونان من طابقين يصل بينهما سلم حلزونى وسطه عمود حجري، وللباب فتحة مستطيلة، أعلاها عقد فوقه النص التأسيسى للبوابة مكتوب بالخط الكوفي، كما يحتوى على نص مذكور فيه أسماء الخليفة المستنصر وأمير الجيوش، أما الطابق الثالث فتوجد فيه حجرتان للدفاع من مستويين بينهما مزاغل للسهام وسقاطتان جانبيتان للدفاع عن الأجزاء الداخلية، وقد تأثر الباب بالطراز المعمارى البيزنطى.
باب الفتوح
بناه جوهر الصقلى عام1078 م/480هـ فى الضلع الشمالى لسور القاهرة، وتم ربطه بباب النصر من خلال سور يصل بينهما، ويحتوى على سراديب ودهاليز، وقد شيد الباب عندما قام بدر الجمالى بتجديد سور القاهرة، ويتكون من برجين كبيرين مستديرين، يحتوى كل برج على حجرات الغرض منها هو الدفاع عن القاهرة، وقد تم زخرفة الباب بالزخارف والحشوات المعقودة التى تضم صنجات تم تعشقيها بعضها البعض، وللبوابة مدخل خشبى نصف دائرى تعلوها عتبة حجرية.
باب زويلة
هو ثالث الأبواب المشيدة فى العصر الفاطمى وأكبرها، حيث قام بدر الجمالى ببنائه عام 485هـ- 1092م، ويقع فى الضلع الجنوبى فى سور القاهرة المربع، يرجع اسمه إلى قبيلة «زويلة»، وهى من قبائل البربر فى شمال إفريقيا، وقد استوطنت القاهرة فى عهد جوهر الصقلى بعد أن انضمت إلى جيش جوهر الصقلي، وكان للبوابة مدخلان أو فتحتان، تم تخصيص الأولى لدخول الأهالى بعد دخول المعز لدين الله الفاطمى منها عندما زار القاهرة، والثانية لخروج الجنازات، ثم أصبحت فتحة واحدة بعد تجديد السور.
يتكون الباب من برجين مستطيلين يقع أعلى كل برج حجرة للدفاع والمراقبة، ويشبه بوابة النصر والفتوح فى التصميم المعمارى، ولكن ما يميزه وجود كرسى فوق عقد فتحة الباب للمراقبة، ثم أصبح لمراقبة التجارة والأسواق، والبوابة خالية من الزخارف، ولكن ترجع شهرة الباب إلى أنه كان يستخدم فى تعليق المحكوم عليهم بالإعدام طوال العصر المملوكى والعثماني، حيث علق عليه رسل هولاكو الذين حملوا رسالة تهديد من المغول لقطز. باب الفرج
تم بناؤه فى سور القاهرة الجنوبى بجانب ضريح «الست سعادة»، ولم يعد له وجود الآن.
باب القراطين أو المحروق
كان يقع بالضلع الشرقى من سور القاهرة، على مسافة نحو 50 ذراعًا من الباب المحروق الحالى، على يد الأمراء المماليك ردًا على مقتل قائدهم عز الدين أقطاى، الذى قتل فى القلعة، ثم قام صلاح الدين الأيوبى بإعادة بنائه مرة عام 1176م، وهو غير موجود الآن.
باب البرقية
بناه جوهر الصقلى عام 970م فى الجانب الشرقى للسور، وكان معروفًا باسم» باب الغريب»، لأنه كان يقع شرق جامع الغريب، وظل موجودًا حتى عام 1936م، وكان مسجلًا فى سجلات الآثار الإسلامية حتى تم هدمه سنة 1936 لبناء جامعة الأزهر.
باب سعادة
يقع فى الجزء الغربى للسور، وتم بناؤه عام 969م على يد القائد جوهر الصقلى، وقد سمى باسم سعادة نسبة لـ«سعادة بن حيان» غلام المعز لدين الله، ولم يعد له وجود فى وقتنا الحاضر.
باب القنطرة
كان يقع بالضلع الغربى للسور، وقد سمى» القنطرة» نسبة إلى القنطرة التى بناها جوهر الصقلى، وتقع على الخليج المصرى عام 360 هـ لرد غارات القرامطة، وتم هدمه فى العصر المملوكى عام 1270م. ولم يعد له أثر.