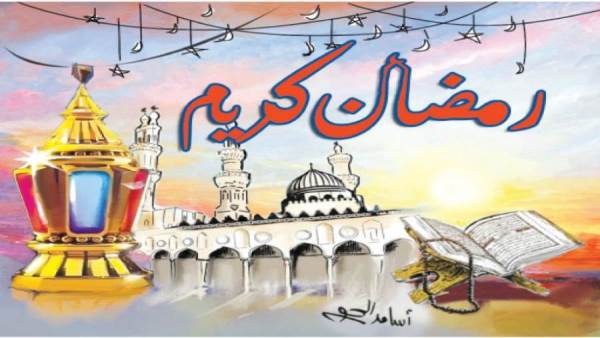محمود عبد الكريم
الثقافة السمعية ما لها وما عليها!
«إن الثقافة السمعية من أخطر الأشياء لأن الإنسان لا يفكر فى المعلومة، لكنه يرددها لذلك أقول إن الإعلام فى كارثة، كما أن السوشيال ميديا ساهم فى نشر العديد من الأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة، وأصبح الجميع يردد الشائعات دون تحرى الدقة، وهذا أخطر شىء على شبابنا المرحلة القادمة».
بهذه العبارات لخصت الكاتبة لميس جابر خطورة الثقافة السمعية التى أصبحت سمة طاغية فى أيامنا هذه بعد أن انصرف الجميع عن القراءة والتحقيق فى المعلومات من مصادرها حتى استسلم العقل الحديث للمعلومة الجاهزة سواء أكانت شائعة أم موثوقة وهذا أخطر المؤثرات التى يتعرض لها شعب من شعوب الأرض.
الثقافة السمعية ثقافة بدائية تمجد النقل، وتتعامل مع ملكتى الحفظ والاختزان التى يحتوى عليهما العقل، دون أدنى التفات للملكات الأخرى الخاصة بالإبداع، كالتحليل والربط والنقد والاستنتاج.
باختصار شديد الثقافة السمعية تنتمى الى المراحل البدائية التى مرت بها الظاهرة الثقافية.. ولو دققت النظر جيدا فى التاريخ البشرى لوجدت أن الثقافة السمعية كانت هى الصيغة السائدة أثناء الفترات التى شهدت سيطرة الكهنوت المطلقة على المجتمعات البشرية، فى حين أن هذه الثقافة بدأت فى الانحسار مع تنامى النزعة العلمية والعقلية لدى أية ثقافة من الثقافات.
قبل الراديو والتليفزيون والإنترنت، كان المصدر الوحيد للأخبار «الحكواتى»، والذى كان أيضا وسيلة التسلية المفضلة، والحكواتى يتمتع عادة بقدرات مميزة فى السرد والخطابة؛ وكان حتى يستحوذ على انتباه السامعين يضفى على حديثه عناصر التشويق والمبالغة، واختلاق الأخبار وفبركة القصص، إذا لزم الأمر.
اليوم، انتقلت هذه «الصنعة» بكل مزاياها وسماتها إلى الأدوات الحديثة، أى إلى وسائل الاتصال التكنولوجية، وظل نفس جمهور المستمعين، يصغى لهذا الحكواتى الجديد، بنفس الآلية القديمة، ويبنى ثقافته، ومواقفه السياسية، حتى وشخصيته الفكرية، بناء على ما يسمعه منه فقط.. ونعنى بهؤلاء من يكتفون بسماع نشرات الأخبار وتحليلات «الخبراء الاستراتيجيين» الذين تستضيفهم المحطات الفضائية المختلفة.. ونضيف إليهم من يستمدون ثقافاتهم من منشورات فيسبوك وتويتر، السريعة والسطحية.
ولا نستغرب حين نشاهد متعلمين وخريجى جامعات، ومنهم من بلغ درجات أكاديمية متقدمة لكنهم يصنفون ضمن فئة «جمهور المستمعين»، ذلك لأنهم لم يقرؤوا شيئا خارج نطاق تخصصهم، وظلت العوالم الأخرى بالنسبة لهم غامضة، مع أنهم بالطبع لا يعترفون بذلك.
وفى المقابل، هنالك من يستمدون ثقافاتهم من الكتب والروايات والدوريات والصحف والمراجع الرصينة.. أى جمهور القراء.
لكن بعض من يحسبون أنفسهم من «جمهور القراء»، تجدهم بالكاد يقرؤون كتابا أو كتابين فى السنة، وصارت قراءتهم تقتصر على المنشورات القصيرة والسريعة. على أى حال تلك هى سمات المرحلة؛ حيث صار الناس فى هذا الزمن «السريع» يفضلون كل شىء سريع وقصير: الوجبات، الأغاني، المقالات.
وفى الواقع، ثمة فارق كبير بين جمهور المستمعين، وجمهور القراء.. وبالتالى فرق كبير بين الثقافتين.
الثقافة السمعية، تعتمد فقط على التناقل الشفهى، والقراءات المبتورة والمجتزأة، وبالتالى لا تقدم علما يعتد به، ولا تعطى خبرا صحيحا، ولا تبنى ثقافة محترمة.. بل هى فى أغلب الأحيان مجرد شائعات، أو قصص مفبركة وأخبار زائفة، أو عبارة عن استنتاجات متسرعة، وتحليلات خاطئة، لأنها تفتقر لأسس التفكير المنطقى، ولأنها غير موثقة، ومنزوعة من سياقاتها العامة.
وعندما تُبنى أى معرفة استنادا للسمع فقط، عادة ما تكون ناقصة ومشوشة، بل إنها كثيرا ما تعكس جهلا فاحشا بالموضوع، لذلك هى ثقافة مدمرة للعقول ومدمرة للمجتمع.
الثقافة السمعية الآن الأكثر انتشارا فى أغلب المجتمعات، لأنها أسهل، ولا تتطلب جهدا، وهى تحاكى الطبيعة البشرية بنزعاتها البدائية وأمراضها ونواقصها، وهى تناسب أكثر أولئك المفتونين بنظرية المؤامرة، أو الذين تستهويهم قصص الفضائح، والإثارة، وحياة الناس الخاصة (بالذات المشاهير).. لهذا، عندما تنتشر أخبار تتضمن جوانب سلبية، وفضائح، أو اتهامات لآخرين.. تجد رغبة عجيبة لتصديقها، وترويجها، حتى لو كانت تتناقض مع أبسط الحقائق المعروفة والموثقة.
والسبب فى ذلك، أن الناس لا تسعى لمعرفة الحقيقة، بل هى غير مهتمة بها أصلاً، تفضل الكذب الجميل على الحقيقة المرة، الناس بطبعهم يميلون لتصديق الروايات السيئة عن الآخرين، ويجدون فيها تعويضا عما ينقصهم، وعزاء لخيباتهم وضعفهم، وفرصة للتعبير عن غضبهم المكبوت، يفعلون ذلك بنوع من التطهر، ليظهروا أمام أنفسهم وأمام الآخرين كما لو أنهم ملائكة، وأشخاص مثاليون، وكأنَّ حياتهم بلا أخطاء.. ربما تكون تلك القصص والأخبار ساذجة، وغير قابلة للتصديق إطلاقا، لكن حب الإثارة، والرغبة للخروج عن المألوف، تجعل الكثيرين يعيدون إنتاج تلك القصص والأخبار والتعليق عليها، مع التهويل وبناء استنتاجاتهم الخاصة، والمرعبة.
وبفضل الانتشار غير المسبوق لوسائط التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، التى لا تلتزم بمعايير العمل الصحافى.. صار المواطن بديلا عن الإعلام الرسمى للأنظمة فى ترويج الشائعات والأخبار، أو فى نشر ثقافة التجهيل والسطحية، من خلال تلك المنشورات التى تمتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعى، والتى أقل ما يقال عنها أنها سذاجة.
ولا بد من التأكيد، على أن الثقافة السمعية بحد ذاتها ليست خطأ؛ فالاستماع صار من ضرورات العصر، لكن الاعتماد عليها فقط، دون مصادر المعرفة الحقيقية، وأهمها الكتب، يخلق ثقافة مشوهة.
اليوم، توفر التقنيات الحديثة إمكانية تحويل الكتب إلى محاضرات سماعية، وقد لجأ العديد من المفكرين والمنظرين والعلماء والأدباء إلى تقنية السمع، أى بدلا من تأليف كتاب، يسجله، وفيه يحكى كل ما أراد كتابته، وهذا له جمهور واسع، وآخذ بالازدياد.. وقد يجمع بين التأليف والكتابة مع التسجيل والتوثيق بالصور.. إلى جانب الكتب الناطقة التى كانت مصممة أساسا للمكفوفين، ثم انتشرت بسرعة، لأنها مناسبة لمطالعة كتاب فى الأتوبيس، وأثناء الانتقال.
لقد أصبح مألوفا رؤية بعض المواطنين وهم يضعون فى آذانهم سماعات «هدفون»، أثناء تجوالهم، فإذا كان ما يسمعونه أغانى، فستمنحهم طاقة وحيوية، وإذا كان كتبا ومحاضرات ستعطيهم معرفة.
ولكن، يبقى خير جليس فى الزمان كتاب.. له ملمس، ورائحة، وشعور خاص لا يعرفه إلا من اعتاد على القراءة والمصداقية.